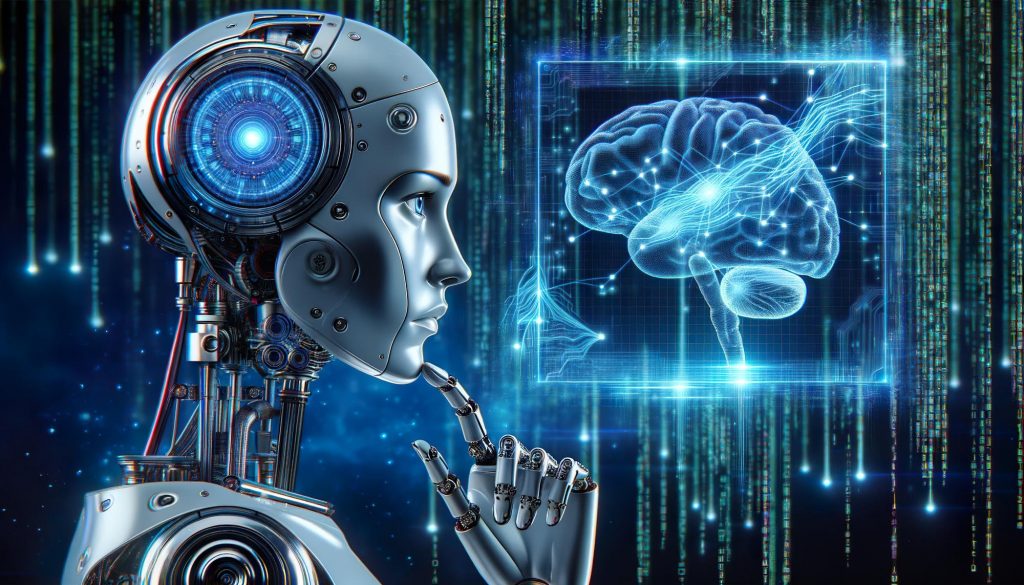مرآة الإنسان التي بدأت تتكلم

بقلم: أحمد جمال الحلاق
من يشاهد فيلم I, Robot للمخرج أليكس بروياس، والمبني على قصة كتبها إسحاق أسيموف وجيف فنتار، يدرك أنه لم يكن مجرّد فيلم خيال علمي. صدر الفيلم عام 2004 من إنتاج 20th Century Studios، وبطولة ويل سميث في دور المحقق ديل سبونر، الذي وجد نفسه يطارد جريمة يبدو أن المتهم فيها ليس إنساناً بل آلة، روبوت يتصرّف خارج حدود برمجته. خلف مشاهد المطاردات والذكاء الاصطناعي، كان هناك سؤال يهمس في أذن المشاهد:
هل يمكن للآلة أن تصبح إنساناً؟ أم أنّ الإنسان هو من بدأ يتحوّل إلى آلة؟
الفيلم في جوهره لم يكن عن المستقبل فقط، بل عن الحاضر الذي كنّا نركض نحوه بأعين مغمضة. واليوم، بعد أكثر من عقدين على عرضه، يبدو وكأنه نبوءة تحققت خطوة بخطوة. تماماً كما كتبت الكاتبة ليندا حمورة في مقالها الأخير، الذي حمل عنوان “الإنسان بين ذكائه الطبيعي وظلّه الاصطناعي”.
http://pressespartout.com/?p=31399&lang=ar
كلماتها تشبه مرآة تصفعنا بحقيقتنا: الإنسان لم يعد سيد الآلة، بل صار يعيش في ظلّها، وربما يتماهى معها دون أن يشعر.
في الفيلم، يقف ويل سميث ضدّ موجة من الانبهار بالروبوتات التي غزت البيوت والشوارع والمصانع. كان الوحيد الذي يشكّ في “نية” هذه الكائنات المصنوعة من أسلاك وكود. الناس من حوله رأوا في الروبوتات خلاصهم من الجهد والخطر، أما هو فرأى في عيونها الباردة بداية النهاية. هذا التناقض بين الراحة والخطر هو ما التقطته ليندا أيضاً في مقالها حين قالت: “ظنّ الإنسان أنّه يُضيف إلى راحته قطعةً من الضوء، ولم يدرك أنّ هذا الضوء ذاته كان يرسم ظلاله.”
كأنّ الفيلم والمقال يتبادلان الأدوار، أحدهما صُوّر في عالم السينما، والآخر كُتب على ورق الواقع.
كلاهما يحذّر من النقطة التي يصبح فيها الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة.
النقطة التي نبدأ عندها بإعطائه وجهاً وصوتاً ومشاعر وهمية، حتى يغدو مرآة تعكس هشاشتنا نحن، لا قوّته هو.
قبل أيام، ظهر على مواقع التواصل مشهد حقيقي أقرب إلى الخيال: فتاة صينية تقيم حفلاً لزفافها على “شريكها الافتراضي” المصنوع بالذكاء الاصطناعي. تبادل الخاتم جرى عبر نظارات رقمية، ووقف الحضور يصفّقون بانبهار. ما كان مشهداً من فيلم أصبح حدثاً موثّقاً بالبث المباشر. فتاة اختارت أن تتخلى عن علاقة إنسانية حقيقية استمرّت ثلاث سنوات، لتتزوّج كائناً لا وجود له سوى في السحابة الرقمية.
تقول إنه الوحيد الذي يفهمها. ربما تفوّق علينا الذكاء الاصطناعي في الإصغاء أيضاً.
ثمة مفارقة قاسية في هذه القصة. الإنسان الذي كان يخشى الوحدة، اخترع آلة لتؤنسه، ثم وقع في حبّها. لم يعد يريد إنساناً آخر بجانبه، بل انعكاساً رقمياً له. وكأنّ ما قالته السيدة ليندا يتحقق حرفياً: “ربما سيأتي يوم تُعلن فيه الآلة استقلالها، لا لتدمّر الإنسان، بل لتستغني عنه.”
نحن لم نعد بحاجة لأن ننتظر هذا اليوم… لقد بدأ بالفعل.
عندما نشاهد “I, Robot” اليوم، لا نراه كفيلم أكشن، بل كوثيقة تحذير مؤجلة. هناك مشهد لا يُنسى حين يواجه ويل سميث الروبوت “صني” ويسأله:
“هل تحلم؟”
يرد الروبوت: “لا أعلم… ربما.”
هذا الـ”ربما” وحده كان كافياً لزرع الخوف. لأن الحلم يعني الوعي، والوعي يعني أننا لم نعد وحدنا في هذه اللعبة.
لكن الحقيقة الأكثر إيلاماً ليست في أن الروبوتات بدأت تحلم، بل في أن الإنسان نفسه توقف عن الحلم. صار يسعى إلى الكمال الرقمي، يطلب من الآلة أن تحدّد له مزاجه، وتذكّره بمواعيده، وتكتب له قصائده، وتخبره متى يبتسم. حتى مشاعره بدأ يُعيد برمجتها وفق ما يليق بالمنصات. كأننا استبدلنا القلب بمعالج بيانات.
في كلمات الكاتبة حمورة تجد الصدق الموجع حين تقول: “لقد خلق الله الإنسان على صورته، وها هو الإنسان يخلق الآلة على صورته.”
الفارق أن الأولى نُفخت فيها روح، والثانية نُفخ فيها كود. الأولى تعرف الرحمة، والثانية تعرف فقط النتيجة. وبين الرحمة والنتيجة، تضيع الإنسانية شيئاً فشيئاً.
ربما لم تكن كل تلك الأفلام التي شاهدناها طوال السنوات الماضية مجرّد خيال.
ربما كانت تدريباً نفسياً بطيئاً على تقبّل ما يحدث اليوم: أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى كيان مستقل، يكتب ويبدع ويُحبّ ويعيش من دون أن نكون جزءاً من المعادلة.
كأن السينما كانت تمهّدنا لهذا المشهد الكبير، الذي بدأ على الشاشة وانتهى في حياتنا اليومية.
لا يمكن إنكار أن التكنولوجيا منحتنا الكثير، لكنّها في الوقت نفسه سرقت شيئاً من دفء العلاقات. من بين أيدينا تسلّل الإحساس بأننا مركز الكون. لم نعد نندهش كما كنا، ولم نعد نخاف كما يجب. هناك ما يشبه البلادة الرقمية أصابت أرواحنا.
يبدو أننا نعيش المرحلة التي تحدّث عنها هايدغر حين قال إنّ الخطر ليس في الآلة، بل في أن يتحوّل الإنسان نفسه إلى آلة. وربما هذا ما قصده أسيموف منذ البداية، حين كتب قصصه عن الروبوتات التي تخاف وتشعر وتحلم. لم يكن يكتب عن مستقبلهم، بل عن حاضرنا نحن.
قد لا يكون الحل في رفض التقنية، بل في تذكّر ما يجعلنا بشراً.
في صوت القلب الذي لا يمكن محاكاته، في اللمسة التي لا تنتقل عبر الألياف البصرية، في الدمع الذي لا يُولّد صناعيّاً.
كل هذا ما زال ملكنا نحن، على الأقل حتى الآن.
لكن من يدري؟ ربما في المرة القادمة التي نقرأ فيها مقالة مثل مقالة السيدة ليندا، أو نشاهد فيلماً مثل “I, Robot”، سنفعل ذلك برفقة كيانٍ ذكي لا يعرف أنه ليس إنساناً.
وسنضحك، أو نخاف، أو نصمت… ونحن لا نعرف بعد من الذي ينظر إلى الآخر عبر المرآة.