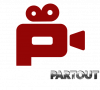بقلم ليندا حمّورة
في الماضي، كانت الغربةُ مجرد مسافاتٍ بين القرى والمدن، بضعةُ كيلومتراتٍ تفصل الأخ عن أخيه، والابن عن أمه، وكان الحنين يُختصر برسالةٍ تُحملُ مع عابرِ سبيل. كنا نظن أن ذلك البُعد كان قاسيًا، ولكننا لم ندرك أن الأشد قسوةً قادمٌ في الغد.أما اليوم، فلم يبقَ بيتٌ في هذا الوطن إلا وفيه قلبٌ نصفه هنا ونصفه الآخر على ضفاف الغربة. صار البحرُ بيننا وبين أحبابنا، وصار الفراقُ عادةً، والهجرةُ كالخبز اليومي، لا تنقطع.هل سألنا أنفسنا لماذا؟
لماذا صار الوطنُ يضيّق على أبنائه، بدل أن يكون لهم حاضنًا؟ لماذا صار الأهلُ يربّون أبناءهم ليودّعوهم في المطارات، لا ليحتفلوا بنجاحهم بين أحضانهم؟ أليس هذا الحزن بعينه؟ كيف لوطنٍ تعلمنا في كتب الجغرافيا أنه “الأجمل”، “الأغنى”، “الأكثر تميزًا بموقعه ومناخه”، أن يتحول إلى محطة رحيل بدل أن يكون وجهة استقرار؟
أليس الوطن كالأم؟
كيف لأمٍ أن تترك أبناءها يرحلون واحدًا تلو الآخر، دون أن تسأل نفسها لماذا يغادرون؟ كيف لدولةٍ أن ترى شبابها يرحلون كما ترحل الطيورُ في موسم الشتاء، ثم لا تسأل كيف تعيدهم حين يزهر الربيع؟
قال الله تعالى في كتابه الكريم:
“المالُ والبنونُ زينةُ الحياةِ الدنيا” ، فكيف لوطنٍ أن يخسر زينته، ثم يتساءل لمَ صار وجهُه شاحبًا؟ أليست ثروته الحقيقية هي عقول شبابه وسواعدهم التي تُشيّد الأوطان؟
إلى متى؟
إلى متى سيبقى الوطنُ منزلاً بلا سكان؟ إلى متى ستبقى السياسةُ عاجزةً عن احتضان شبابها، عن منحهم ما يستحقون، عن جعل الوطن أكثر من مجرد محطةٍ مؤقتةٍ في طريق السفر؟
يا دولتنا الكريمة، أفيقي قبل أن يصبح الوطن “أرضًا بلا أصحاب”، قبل أن يصبح ذكرى يرويها المغتربون لأولادهم قائلين: “هنا كنا، وهنا تركنا قلوبنا!